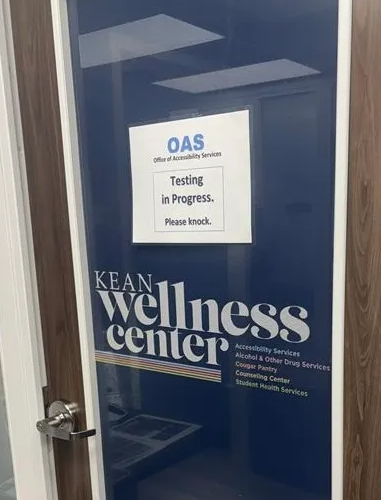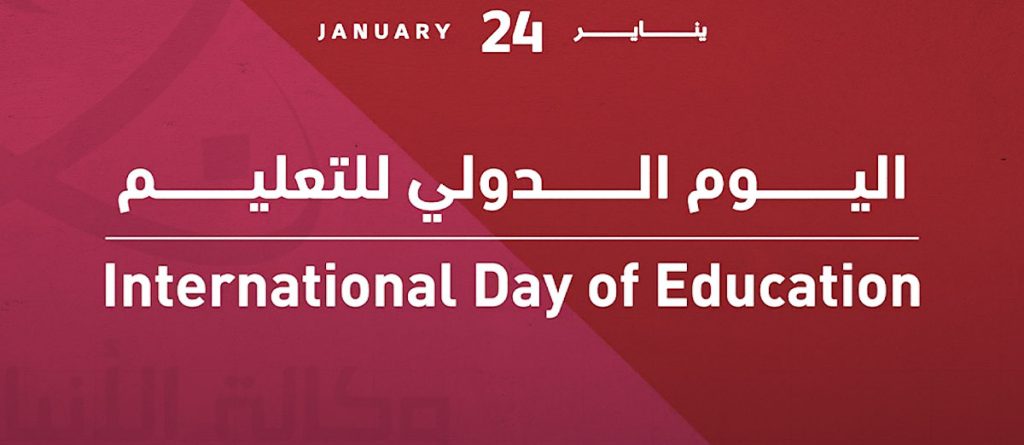في الزوايا المظلمة من المؤسسات وخلف الأبواب المغلقة لدور الرعاية، وفي الغرف التي يفترض أن تكون آمنة، يزدهر العنف الذي لا يرى، ليس لأن أحدا لا يسمع الصراخ بل لأن الضحايا أنفسهم قد لا يملكون القدرة أو الوسيلة للتعبير عن الألم، إنها مأساة أولئك الذين يعيشون على الهامش أي الأشخاص ذوو الإعاقة، وليست حكاياتهم عنفا عابرا بل نمطا ممنهجا من الإيذاء الممأسس، يرتكبه في الغالب من يفترض أن يحميهم.
ومن يتابع وسائل الإعلام التقليدية وحتى السوشيال ميديا، حتما سيقرأ يوميا عن حالات تعدي واعتداء على معاقين هنا وهناك.. من اعتداء جنسي على فتاة معاقة ذهنيا، للاعتداء البدني على معاق حركي صغير السن، وغير ذلك.
الإحصاءات في مجتمهنا العربي كما في العالم ككل، تفصح عن فاجعة مخفية فالأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بغيرهم، وهذا لا يشير فقط إلى التكرار بل إلى نمط من الإجرام المستمر طويل الأمد، الذي يستغل هشاشة الضحية ويعتمد على الإفلات شبه الكامل من العقاب،
وتشير تقارير إلى أن هذه الاعتداءات سواء كانت جنسية أو جسدية أو نفسية أو اقتصادية، تتسم بشراسة استثنائية وكأنها تستهدف ليس الجسد فقط بل الكرامة الإنسانية ذاتها.
في كثير من الحالات لا تقتصر المعاناة على الإعاقة فقط، بل تتقاطع مع عوامل أخرى تزيد من هشاشة الضحية، كالنوع الاجتماعي أو السن أو درجة الإعاقة، والنساء ذوات الإعاقة على سبيل المثال يواجهن خطر العنف من الزوج أو الوصي بمعدلات تصل إلى أربعة أضعاف نظرائهن غير المعاقات، كما أن الأطفال ذوو الإعاقات العقلية يصبحون أهدافا مفضلة للمعتدين، لعلمهم بأن الضحية لن تكون قادرة على تذكر التفاصيل أو حتى إدراك فظاعة ما حدث، ما يعني أن المعتدي لن يحاسب غالبا.
وإذا كان الخوف من الغريب حاضرا في أذهان الناس، فإن الواقع أكثر قسوة فالجناة في هذه الحالات لا يأتون من الخارج بل من الداخل، من أقرب الدوائر مثل الأسرة ومقدمو الرعاية والمربون والسائقون بل حتى من الأطباء والممرضون أحيانا.
في 99% من حالات الإساءة الجنسية ضد ذوي الإعاقات يكون الجاني معروفا للضحية، العلاقة بين المعتدي والضحية قائمة على ثقة مفقودة واستغلال مخطط له،وتحويل لأدوات الرعاية إلى أدوات تعذيب.
سيكولوجية الجاني. عقل يخطط للإفلات
تظهر تحليلات علم النفس الجنائي أن استهداف ذوي الإعاقة ليس فعلا اعتباطيا بل خيارا محسوبا، حيث الجاني يدرك أن الضحية تمثل هدفا مسهلا، من حيث احتمالية الإبلاغ أو حتى التصديق إن أبلغت، ويجري المعتدي ما يشبه الحسابات فمثلا المكسب (إشباع رغبة مادية أو جنسية أو نفسية) مقابل الخطر (انكشاف الجريمة)، وفي ظل صمت الضحية وعجز النظام وانعدام الأدلة تبدو الجريمة فرصة مغرية لا تقاوم.
لكن الأمر لا يتوقف عند الحسابات فالجاني يحمل غالبا تحيزا إدراكيا عميقا يبرر به لنفسه العدوان، يرى أن له الحق في السيطرة، في فرض سلطته على من يراهم أقل منه قيمة، ويغيب التعاطف كليا، ليحل محله شعور بالتفوق المرضي، في حالات كثيرة، يكون العنف نفسه وسيلة لإذلال الضحية، لا مجرد وسيلة لإشباع رغبة آنية، وفي العمق قد يكون هذا الفعل انعكاسا لصراعات داخلية دفينة، صراعات تبدأ من الطفولة وتنمو في بيئة بلا رعاية نفسية.
في تفسير التحليل النفسي لا يكون الاعتداء مجرد قرار واع، بل عملية لا شعورية لتعويض حرمان داخلي أو شعور مزمن بالنقص، الهو ينتصر على الأنا الأعلى والدوافع المكبوتة تجد متنفسا في جسد الضحية الضعيف، في هذه الصورة تتحول الجريمة إلى محاولة لاستعادة سيطرة مفقودة على الذات عبر تدمير ذات الآخر.

أدوات السيطرة وعنف لا يرى
الاعتداءات لا تكون جسدية فقط، فكثير من الجناة خاصة ممن هم في موقع سلطة أو رعاية، يفضلون استخدام أساليب أكثر هدوءا.. وأكثر فتكا. حجب الأدوية، التحكم في الغذاء، حرمان من المساعدة الحركية، أو التلاعب بالمستحقات المالية، كلها أدوات تستخدم لفرض السيطرة، ولتعزيز تبعية الضحية واستسلامها.
في هذا السياق، تتحول الإعاقة من حالة طبية إلى أداة للابتزاز فالشخص المعاق يجبر على الاختيار بين التعرض المستمر للإيذاء، أو فقدان الرعاية الأساسية التي تعتمد عليها حياته، وهذا ما يعرف بفخ الاعتمادية وكلما زادت عزلة الضحية عن المجتمع كلما سهل التحكم فيها، في المؤسسات المغلقة يصبح الجاني سيد الموقف ولا من يسائل.
ولا يحدث هذا العنف في الفراغ بل يزدهر في تربة اجتماعية خصبة بالتمييز والوصم والجهل، والمجتمعات التي تنظر إلى ذوي الإعاقة كعبء أو كائنات ناقصة تخلق بيئة تبرر للجلاد جريمته، وتشكك في رواية الضحية، ولا يصدق المجتمع الضحية لأنها «لا تفهم» أو «تتخيل»، أو لأن الجاني «محترم ويستحيل أن يفعل ذلك».
ويزداد الطين بلة في غياب آليات توثيق واضحة، فمعظم حالات الاعتداء لا تسجل ولا تحقق، ولا تدخل في الإحصائيات، هذا الغياب ليس مجرد خلل إداري، بل حماية فعلية للمعتدي من أن يحسب أو يلاحق. عندما لا ترى الضحية في الأرقام فهي لا ترى في السياسات ولا تخصص لها حماية ولا موارد ولا برامج تدخل. إنها جريمة تخفي نفسها بالنظام وتنجو منه.
الاستجابة بين العلاج والردع
مع هذا الواقع المأساوي لا يكفي التركيز على الضحية وحدها، بالطبع يجب توفير الدعم النفسي والتأهيل والحماية الفعلية، خصوصا في حالات الإعاقة الذهنية التي تحتاج تدخلات علاجية متخصصة، ولكن الأهم هو معالجة مصدر الخطر نفسه وهو الجاني.
ما تزال أغلب البرامج تركز على دعم ذوي الإعاقة دون أن تمس الجاني، حيث لا توجد برامج تأهيل نفسي وسلوكي تستهدف المعتدين على ذوي الإعاقة، رغم معرفتنا بأن الكثير منهم يعاودون الفعل إن لم يعالجوا، وهنا تظهر الحاجة إلى برامج علاج معرفي سلوكي، وتدخلات علاج نفسي تهدف إلى معالجة التفكير المشوه، والعدوان التعويضي والدوافع اللاشعورية التي تقود إلى الاعتداء.
وبالتوازي لا بد من إصلاح تشريعي واضح يمنع الثغرات ويضمن المحاسبة ويوفر حماية حقيقية، خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية، ممن يواجهن أسوأ أنواع العنف بلا حماية كافية، الإصلاح يجب أن يشمل إشراك منظمات ذوي الإعاقة في رسم السياسات، وتصميم آليات الشكاوى وتقديم الدعم للضحايا.
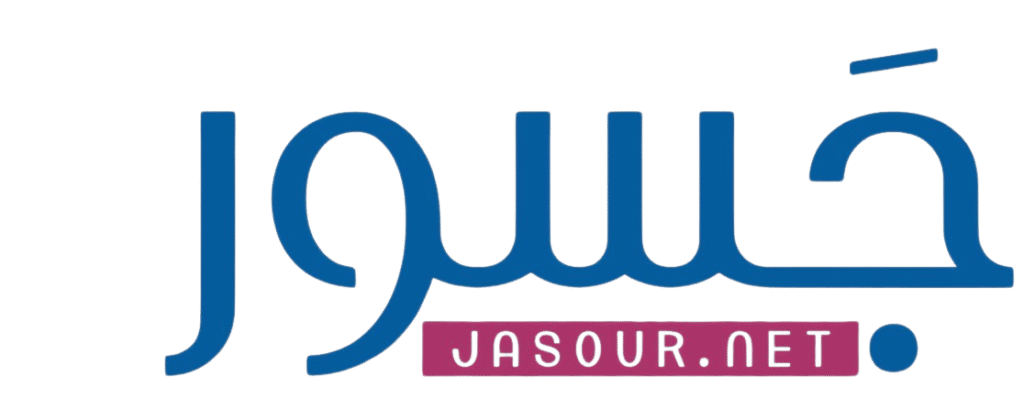
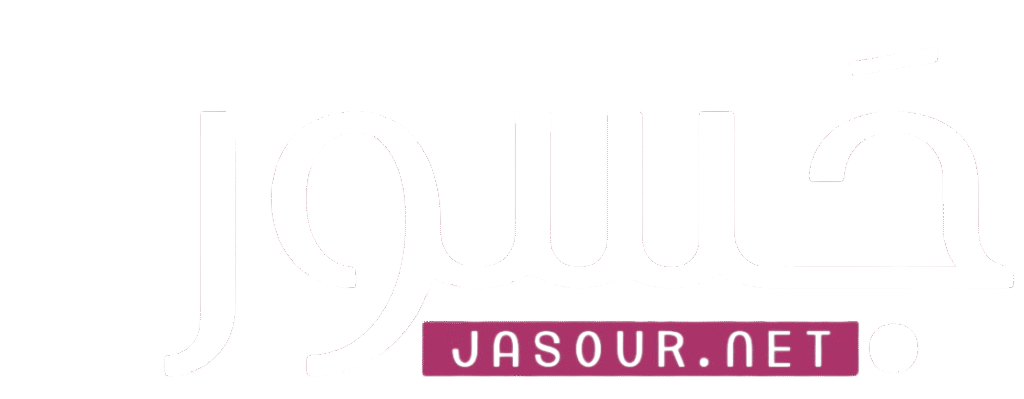
.png)