في بداية السبعينات شهدت حركة الصم الاجتماعية أول بدايتها بقيادة أبونا مصطفى شمس الدين بالخرطوم نمرة ٢، تجمعات الصم بجمعية الصم التي أسسها بروف طه طلعت، جراح الأذن والأنف والحنجرة.
فكانت البداية الحقيقية لمجتمعات الصم الخالصة ببحري حي الأملاك، بعد وقع اختيارهم ومشورتهم على تكوين اتحاد بها، قبلها كان الجميع مترددين بين بحري وشارع السيد عبد الرحمن أن يكون المقر، الذي أصبح فيما بعد بنك العمال، ولكن بإصرار أبونا مصطفى شمس الدين تم تثبيت الدار بحي الأملاك، وما زال قائمًا للآن منذ السبعينات إلى أن دمرته الحرب وتخريبه وتعرضه للسرقة.
كانت الفكرة للتأسيس كاتحاد رياضي، لكن غلب عليه الجانب الاجتماعي والأنشطة المتعددة للصم في سبعينات القرن الماضي ومتنفس لهم، حيث شكّل الاتحاد تطور لغتهم وتوسعها وشمولها.
حظي الاتحاد بالجيل الأول من المتعلمين مثل الأستاذ حسان محمد عبد الرحمن جميل، المحاسب بإحدى الشركات والبنوك، مع إجادته للغة الإنجليزية، سبق له الإقامة ببريطانيا أثناء ابتعاث والده، وهو من أسر توتي العريقة، كما هو عضو من المؤسسين لجمعية الصم.
بالتركيز على اتحاد الصم، كان تحت مسمى “اتحاد الصم والبكم”، يعتبر من أول اتحادات الإعاقة وأعرقها، إلى أن تم تصحيح المسميات علميًا بحذف كلمة (البكم)، تلك الكلمة التي في العقل الجمعي المراد بها منحى سلبي، فترة إعادة التأسيس الحديثة للعام ٢٠٠٣.
العم مصطفى شمس الدين كان الذراع اليمنى للاتحاد ومدير الأمور بقوة وصلابة وانضباط وحفظًا على روح ووحدة الصم، حُكي أن تم منحهم المنزل الحكومي من قبل حكومة مايو، مصدق به من السيد رئيس الجمهورية جعفر نميري، حيث يكون الاتحاد مرتعًا للأنشطة اليومية، بعد يوم شاق يأتي الإخوة له وهم يشكلون طيفًا من المدن الثلاث: الخرطوم، أم درمان، وبحري، ومنهم من توفاه الله إلى جواره، ومنهم من هو قعيد الشيخوخة.
تشكل الوعي الثقافي والاجتماعي للصم بداخل الاتحاد، كان بمثابة لهم البيت الكبير، يكون نقطة الأخبار والتجمعات لمأتم أو معاودة مريض، وتكافلهم فيما بينهم.
في السبعينات والثمانينات لم تكن وسائل الاتصال الحديثة متوفرة، مما أتاح لهم رباطًا اجتماعيًا قويًا، تُحل الخلافات والمشكلات الاجتماعية بينهم بقيادة الأب الروحي مصطفى، فيما بعد ترك القيادة إلى آخرين، تولاها العم عوض وأمثال العم عبد السلام القوصي الذي فتح لهم جبهة اجتماعية خارجية مع جمعية الشباب الصم بالإسكندرية والمعادي والجمعيات المصرية.
رجّح أكثر كبار السن من الصم أن علاقاتهم تقوى مع الإسكندرية وبورسعيد متجاوزة القاهرة، بالسفريات الموسمية والرحلات السياحية والمباريات الودية التي يرتبها القوصي، مما أضاف لهم الكثير من الخبرات المنهجية من تواصل بلغة الإشارة وإيجاد مترادفات لكلمات جديدة، أصبحت فيما بعد قليلة من الإشارات المصرية واندثرت بعامل الزمن وتغيرات الأجيال والحداثة السودانية من الجيل الحالي.
أثناء فترة حكومة مايو لقي الصم الكثير من الرعاية الاجتماعية والاهتمام بالدولة، حيث كان للرئيس نميري حضور لافت ومتكرر بينهم ودعمهم في الكثير من الرحلات السياحية الداخلية، حظوا بزيارة مدن سودانية عديدة مثل: سنكات، هيا، أركويت، جوبا، دارفور، بورتسودان، سنجنيب، حلايب، شلاتين، الكرمك، قيسان…
مما ساعدهم على التكيف الاجتماعي والاندماج، ونقول إن حب الأسفار والرحلات والمغامرة للصم السودانيين أصبح ظاهرة اجتماعية موروثة فيما بينهم إلى الآن.
كيف تشكلت ثقافة الصم؟
ساهم وعيهم الفطري والغريزي في تشكيل الوعي لديهم، وعبر مكتبات الفيديو، الصور الفوتوغرافية، الحضور المجتمعي، حيث كانت الخرطوم في ذلك الزمان منفتحة اجتماعيًا وسكانها يعرفون بعضهم.
سينما كازيون (ملتقى عيادة البروف)، سينما حلفاية، وتكوين شلليات وتجمعات مع الجهات الأخرى، لم تكن بالصورة العلمية والمؤسسية المعروفة بالنظر إلى الألفية الجديدة وبداياتها، وضم الاتحاد لعضويته من الصم أنفسهم حاملي الشهادات والدرجات العلمية العليا والمثقفين، أصبح لديهم تغيير كبير بعد إعادة تأسيس الاتحاد ١٩٧٠ – ٢٠٠٣ وتخصيص فروع له في كل الولايات حتى جنوب السودان قبل الانفصال.
عمل الاتحاد على تحديث منظومته الاجتماعية والثقافية، وجعلها ضمن إحدى الأمانات التنفيذية، وشكل علاقات واسعة مع المنتديات والمراكز الثقافية، بوجود الأستاذة التشكيلية آمال الرفاعي في مجال الفن التشكيلي، قدمت صورة ذهنية ثقافية صحيحة عن مجتمعات الصم.
وإن الاحتفاء بأسبوع الأصم العربي واليوم العالمي للإعاقة، الذي ينظمه اتحادهم بإقامة المسرحيات الصامتة، منتوج ثقافي خالص بهم بما يسمى مسرح البانتومايم (Pantomime)، وقد حققوا كثيرًا نحو العالمية، بحصولهم على المركز الأول عالميًا في إسبانيا مهرجان تبادل الثقافات العالمي، لم يكن وجودهم قاصرًا محليًا.
أثناء حراكهم الثقافي الحديث، رأينا الإعلام يتحدث عنهم، لكن ليس بالصورة المثلى، عبر الصحف والتلفزيون، وتقديم حراكهم بصورة ركيكة وباهتة، يرجع ذلك لعدم فهم خصوصيتهم الثقافية، يظهر من التحقيقات الصحفية وعدم الإلمام الكافي للصحفي بمجتمعات الإعاقة بشكل عام، ركاكة الحوار التلفزيوني وسطحية الأسئلة، مما أعطى للمشاهد والقارئ السوداني مفهومًا ضعيفًا عنهم لبداية الألفية والتسعينات، أي باعتبارهم فئة مستهلكة ثقافيًا وذات حضور خلفي، ومما اعتبره بذلك ظلمًا لهم.
لا أنسى أن بينهم كتابًا وشعراء ومبدعين من الطراز الأول، أمثال الشاعرة القاصة والناقدة (إيثار يوسف)، محررة ومعدة مجلة المرور وكاتبة بإحدى الدوريات الثقافية وأستاذة بإحدى المدارس العامة للفنون الشاعرة مولانا / غناء عوض حسن، المستشارة القضائية بوزارة العدل، والأستاذ الذي حلق في سماوات بعيدة، مدثر محمد عبد الله، مدير الإعلام، كونه لديه إعاقة حركية مع صمم، عمل مديرًا للإعلام والجودة بوزارة العمل، قدّم الكثير من المؤلفات الأدبية عن دار عزة للطباعة والنشر.
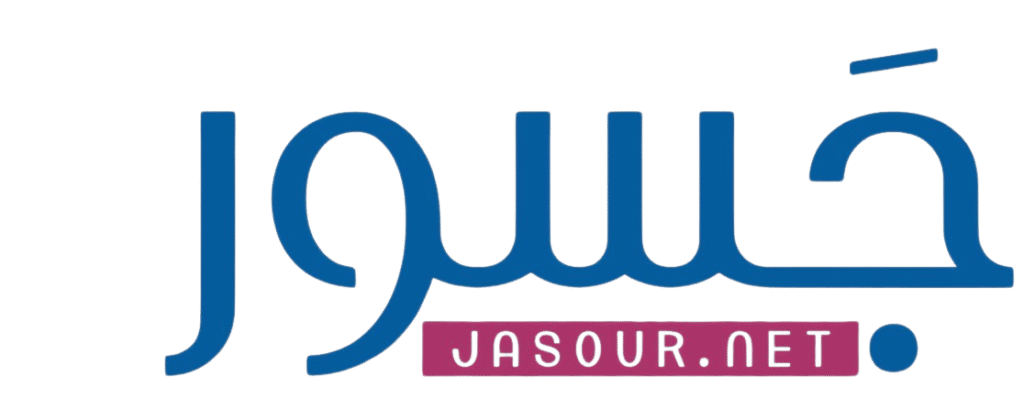
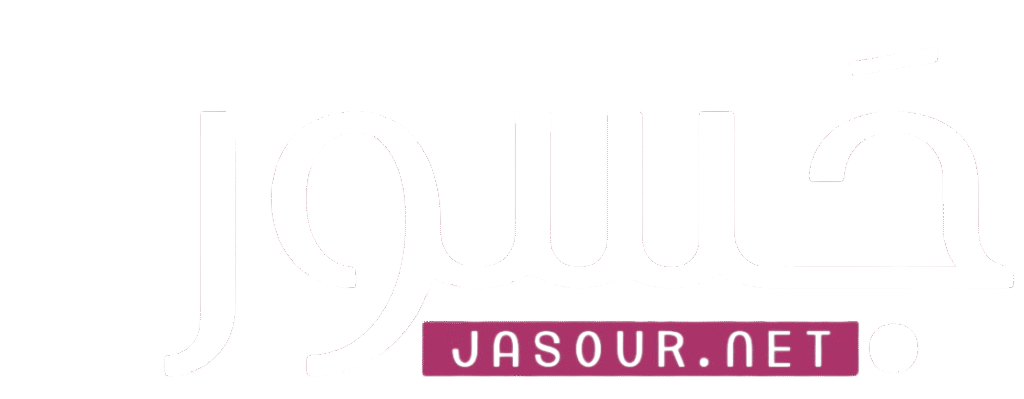
.png)

















































